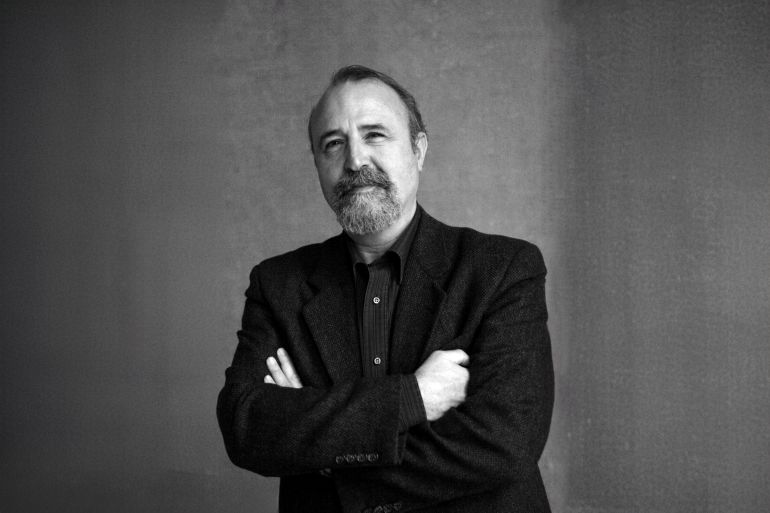أبو العلاء المعري (363هـ-449هـ) علم فريد من أعلام الثقافة العربية، اختلف الناس في أمره، وفي النظر إلى شعره ونثره وفلسفته ومعتقده وطريقة حياته؛ وما يهمنا من أمر هذا الخلاف أن المعري اشتبك مع الناس من كل جيل ولون، وهو أمر يشير إلى أن المعري قد تحول من علم مفرد إلى “ظاهرة” في تاريخ الثقافة، كما غدا محركا أساسيا في مجالات متنوعة: نقدية، ودينية، وفلسفية، وأدبية، ولغوية. يمثل المعري طاقة ثقافية وفكرية وأدبية كبرى في الثقافة العربية، وقد تجاوزت الكتب والبحوث التي تناولته آلاف الكتب والبحوث والمقالات، وتعددت طبقات قرائه واتجاهاتهم وتخصصاتهم، وهذا اختبار لجدية آثاره وعمقها، ومؤشر على بعض ما تتضمنه من نقاط القوة والعمق، وما تستدعيه من القراءة والتأويل. والمعري في هذا التشكيل الفريد حالة قابلة لتعدد القراءات، وهو أمر إيجابي، لأن الثقافة دوما بحاجة إلى من يجددها، ويثير سكونها.
وقد أوجز “الخطيب البغدادي” سيرته في واحدة من أقدم لمحات ترجمته، فقال عنه: “أبو العلاء، أحمد بن عبد الله بن سليمان…المعري التنوخي، ولد لـ3 بقين من شهر ربيع الأول سنة 363. وكان أبو العلاء ضريرا عمي في صباه، وعاد من بغداد إلى بلده معرة النعمان فأقام به إلى حين وفاته. وكان يتزهد ولا يأكل اللحم، ويلبس خشن الثياب…مات في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة 449” [1].
الرحلة البغدادية
وفي سيرته رحلته إلى بغداد سنة 398هـ التي مثلت حدا فاصلا في حياته وثقافته، بما مثلته من تقاطع نضجه الفكري مع ما أفاده من هذه الرحلة وما انتهى إليه بعد عودته إلى بلدته (معرة النعمان)، وقد ذكر أبو البركات ابن الأنباري أنه “.. رحل إلى بغداد سنة 398، ودخلها سنة 99، وأقام بها سنة و9 أشهر، ولزم منزله بعد منصرفه من بغداد سنة 400، وسمى نفسه: رهن المحبسين. وكان عمره [عند وفاته] 86 سنة، لم يأكل اللحم منها 45 سنة” [2].
أما مصنفات المعري، فقد أملى معظمها بعد سنة 400هـ، أي في حقبة عزلته التي تفرغ فيها للعلم والإملاء. ووصلت مؤلفاته إلى 67 مصنفا. ونتوقف في هذه الإضاءة عند شاعرية أبي العلاء في ديوانيه المشهورين: سقط الزند، واللزوميات أو (لزوم ما لا يلزم)، حيث يمثل كل منهما مرحلة عمرية وفكرية، فالأول يمثل المرحلة الأولى من شبابه وحياته حتى رحلته إلى بغداد، وينتهي بدخوله في عزلته المشهورة نحو سنة 400 هـ، وتمثل اللزوميات المرحلة الفلسفية المعمقة التي شهدت نضجه الفكري وتطورت في مرحلة الزهد والعزلة، وشهدت ألوانا متشعبة من تطور الشعر العربي معنى ومبنى.
ابتعد أبو العلاء في معظم شعره عن الأغراض التقليدية، وارتفع بالشعر العربي إلى مناخ جديد يلتقي فيه الشعر مع الفكر، فهو بحق كما وصفه المرحوم طه حسين، الشاعر الفيلسوف الوحيد في شعرنا العربي القديم، فقد جمع بين النظرة الفلسفية إلى الحياة والأفكار والواقع، وإلى التعبير عن هذه النظرة ناقدا وناقما ومصححا في كثر من الأحيان.
يمثل ديوان سقط الزند المرحلة الأولى من شعر المعري، ومعظم ما فيه يمثل إنتاجه حتى سنة 400هـ، وأما سبب التسمية فقد أوضحها المعري نفسه وعنه نقلها شارحو السقط الأوائل، وفي مقدمتهم الخطيب التبريزي تلميذ أبي العلاء: “كان قد لقب هذا الديوان بـ(سقط الزند) لأن السقط أول ما يخرج من النار من الزند، وهذا أول شعره وما سمح به خاطره، فشبهه به. وما أملاه فيه سماه: (ضوء السقط) غير أنه وقع فيه تقصير من جهة المستملي، وذلك أنه استملى معنى بعض أبيات منه وأهمل أكثر المشكلات” [3]. والمقصود بـ(ضوء السقط) شرح أبي العلاء نفسه لديوان سقط الزند. فهو عنوان أول شروح الديوان شرحها المعري وفق ما سأله المستملي. ويوضح التسمية أيضا قول الخوارزمي شارح الديوان: “سماه بسقط الزند لأن السقط أول ما يسقط من الزند عند القداح، ولا يكاد يخرج من الزند إلا بتكلف شديد، والزند ها هنا مجاز عن الطبع، وهذا الديوان أول شعر لفظه طبعه في غرة عمره، وهو قليل متكلف بالإضافة إلى بقية شعره” [4].
ويمثل هذا الديوان بدايات وخطوات قوية للمعري في مضمار الشعر، من ناحية إتقان القول في أغراض متنوعة من الشعر، ومن ناحية ما يكشف عنه من قدرات بيانية ولغوية، وما يعكسه من ثقافة المعري واستيعابه لماضي الشعر العربي، ويبدو من هذا التنوع ومن القول في أغراض معروفة ومجهولة وكأنه يروض نفسه أو يدربها في سبيل الإتقان والإجادة. ولا يخفى أيضا تأثيرات المتنبي عليه في أمور كثيرة، حتى إن شخصيته تكاد تلتبس أو تقترب من طريقة المتنبي في التعبير عن كبريائه وعلو نفسه [5].
ومن هذه المرحلة قصيدة نونية اهتم بها الدارسون لقوة الصورة فيها بما فيها من تصوير الظلمة والنور [6]:
عللاني فإن بيض الأماني فنيت والزمان ليس بفان
ولامية أخرى تذكر بلاميات المتنبي [7]:
ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل
ومنها أبيات شهيرة:
وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل
ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل
فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل
ومن هذه المرحلة داليته التي لا تبعد عن مناخات صاحبه المتنبي [8]:
يكررني ليفهمني رجال كما كررت معنى مستفادا
ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا
فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا
ولي نفس تحل بي الروابي وتأبى أن تحل بي الوهادا
حكيم الشعراء
ومع مسحة الحكمة والتأملات العارضة التي تظل أقرب إلى مدرسة المتنبي هناك ظاهرة الميل إلى البداوة رغم أن المعري حضري، وليس بدويا إلا في أصوله البعيدة، وهذا الميل نفسره بميل الثقافة والتشوق إلى اللغة الخشنة، وهو ليس بدعا في هذا، فقد خرج العرب قبل المعري من بداوتهم، ووسعوا القطاع الحضري الذي كان محدودا قبل الإسلام، ولكنهم حافظوا مع ذلك على بداوة اللغة وحصروا وظيفة الأعراب بوصفهم رسلا أو بريدا للغة العالية التي تكاد تطيح بها الحواضر المختلطة.
وفي سقط الزند مجموعة من القصائد تتعلق بوصف الدروع سميت بـ”الدرعيات”، ولسنا نعرف بالضبط مبعث نظمها عند المعري، أهو الرياضة والسوس أي التدرب على إتقان الشعر، كما كان الحال مع أغراض أخرى؟ فالقصائد لا تتكشف عن غاية واضحة، ولا يظهر فيها ارتباط مع فكر المعري، وإنما هي قصائد تعتمد دقة الوصف، والخبرة الدقيقة في سلاح العرب وأسماء أجزائه وتفاصيله وصناعته، مما يدل من جهة على سعة ثقافة المعري ومعرفته اللغوية والموروثة. وهي إجمالا توسع لموضوع وصفي حاضر في الشعر القديم، وليس الموضوع بحد ذاته جديدا أو لافتا، فقد وصفوا الدرع والقوس والسيف والرمح والبيضة وما إلى ذلك، بل توسع هذا الوصف إلى درجة من الإتقان الرفيع عند الشماخ في وصف القوس منذ أن كان غصنا في شجرة حتى استوت قوسا لا مثيل لها. أما ختام هذه المرحلة فتنتهي إلى قصيدة فذة مميزة ما زالت تتردد كعلامة في حياته كلها. وهي داليته الرثائية [9]:
غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شاد
هذه الدالية بلغت نضجا في التفكير والتعبير، وفي أخبارها أنها قيلت في رثاء فقيه حنفي، اسمه أبو حمزة، توفي قبيل الـ400 أي في نهايات القرن الرابع الهجري. ووفق بحثي فقد وجدت أن المرثي في هذه القصيدة هو أبو حمزة الحسن بن عبد الله بن محمد بن عمرو التنوخي المعري مات قبل الـ400. وهو فقيه حنفي من أقارب الشاعر، ولكن أهمية القصيدة ليست في المبعث الحقيقي لقولها أو نظمها، بل فيما تضمره من بذور عزلة المعري بعيد ذلك بزمن قصير.
لقد خرج من رثاء الفقيه الحنفي إلى رثاء الإنسان من حيث هو كائن، فخرج من الفردي إلى الوجودي، وحشد في هذا التحول حزما من الصور والمتضادات التي جانس بينها أو تمكن من نسجها ليكون وحدة جديدة على مبدأ الصراع والتضاد بين قطبي الحياة والموت، وليعصف سؤال المصير بكل شيء. وسؤال المصير بما فيه من تجاذبات الوجود بين الحياة والموت هو السؤال الذي سيظل حاضرا في مساءلات أبي العلاء في المراحل التالية من حياته.
أما لزوم ما لا يلزم فهو أهم ديوان فلسفي في تاريخ الشعر العربي كله، وقد وضع له المعري مقدمة تشكل أساسا لتلقيه على مستوى الشكل والمضمون، أولها تفسير التسمية التي شاعت مع استعمال المعري لها، وغدت نوعا بلاغيا بديعيا يكرر البلاغيون والنقاد الاهتمام به. وفي المقدمة كشف عن مضامين التفكير ومنازل الرؤية بأسلوب أبي العلاء ولغته المواربة: “كان من سوالف الأقضية (جمع قضاء) أني أنشأت أبنية أوراق، توخيت فيها صدق الكلمة، ونزهتها عن الكذب والميط (الغلو، المبالغة)… فمنها ما هو تمجيد لله الذي شرف عن التمجيد، ووضع المنن في كل جيد. وبعضها تذكير للناسين، وتنبيه للغافلين، وتحذير من الدنيا الكبرى التي عبثت بالأول، واستجيبت فيها دعوة جرول (الحطيئة):
جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنينا
فهي لا تسمح لهم بالحقوق، وهم يباكرونها بالعقوق. وإنما وصفت أشياء من العظة، وأفانين (جمع فن، نوع) على حسب ما تسمح به الغريزة. فإن جاوزت المشترط إلى سواه فإن الذي جاوزت إليه قول عري من المين (الكذب). وجمعت ذلك كله في كتاب لقبته: لزوم ما لا يلزم” [10].
السخرية
وقدم لنا المعري في تأملاته الشعرية لونا جديدا من السخرية المكتومة الجادة، ربما أفاد فيها من الطريقة التي انتهجها المتنبي في بعض شعره ومواقفه، ولكنها بلغت عند المعري مداها البليغ. السخرية التي لا تهدف إلى الإضحاك وإنما تتولد من مفارقات الحياة، وتدفعنا للتأمل قبل كل شيء. ومن ذلك سخريته من كنيته (أبو العلاء) وهو يرى الإنسان يهبط أو ينزل ولا يعلو، يقول [11]:
دعيت أبا العلاء وذاك مين ولكن الصحيح: أبو النزول
ويظهر موقفه الحازم من سياسة عصره في ديوان (لزوم ما لا يلزم) بوضوح، كما في قوله [12]:
مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها
وله قول مشهور في التعبير عن سجونه وعزلته هو قوله [13]:
أراني في الثلاثة من سجوني فلا تسأل عن الخبر النبيث
لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسم الخبيث
ومن خصائص شعره وضوح ظاهرة التصنيع، ومن صورها توظيف المفاهيم والاصطلاحات اللغوية والعروضية والبلاغية وإدماجها في اللغة الأدبية، وهي ظاهرة متميزة تنم عن جرأة فنية من جهة، وعن محاولة للربط بين طاقات هذه المصطلحات والمحتوى الفكري الجديد الذي يعبر المعري عنه. يقول مثلا مستندا إلى دقة المعرفة بالأصوات العربية وطبائعها الصوتية الخالصة [14]:
اجعل تقاك الهاء تعرف همسها والراء كررها الزمان مكرر
فالهاء كما نعرف من الأصوات المهموسة، والراء صوت تكراري، وهو هنا يسترجع هذه الطاقات، ولكنه يريد أن يمتد بها كي تعانق مداها الدلالي، فيغدو تكرار الراء مثلا معبرا عن تكرار الزمن، وهمس الهاء يقترب من التعبير عن التقوى بما فيها من خفوت وجرس خفي.
ويقول أيضا [15]:
وأراع من تربي ولا أرتاع من تربي، وفي قرب الأنيس خطار
وقوله في اللعب على حرفي اللام والباء:
تواصل حبل النسل ما بين آدم وبيني ولم يوصل بلامي باء [16]
ويستوقفنا في هذه الرؤية جملة أمور مهمة في تلقي أبي العلاء وقراءته، منها:
تحيز أبي العلاء للصدق، ونأيه عن “الكذب”، بكل مستوياته، ومن ضمنها غلو التخييل، الذي يدخل في الكذب الفني. ويتراءى في هذا الاختيار مناهضة القول النقدي المشهور: أحسن الشعر أكذبه. وفي هذه المرحلة من التفكير ينتقل المعري إلى قاعدة: أحسن الشعر أصدقه، تفكيرا وتعبيرا.
الموقف من الدنيا: يطور المعري هجاء الحطيئة لأمه، لينتقل به إلى هجاء الدنيا بوصفها الأم الكبرى التي اختلت علاقتها بأبنائها من الطرفين: “فهي لا تسمح لهم بالحقوق، وهم يباكرونها بالعقوق”. وهذا الاختلال أساسي في نظرة المعري، وسينعكس ذلك على هجاء مرير بصور مختلفة للدنيا وإلصاق صفات قبيحة بها، كمخاطبتها بكنية “أم دفر” التي تعني الرائحة المنتنة، أي: أيتها المنتنة! أيتها الجيفة! وهو خطاب أقرب إلى الشتيمة وإعلان العقوق الذي أشار إليه. والأبناء ومنهم المعري لا ينالون منها ما يحسبون أنه حقوق لهم، ولعل منها حقوقا معنوية ومادية، لم ينلها، فقرر أن يكون موقفه الانصراف عن كل شيء.
ويقول متأففا من الدنيا/الأم “الخسيسة” على غير طبيعة الأمهات [17]:
خسست يا أمنا الدنيا فأف لنا بنو الخسيسة أوباش أخساء
ويرى الدنيا بمنظار متشائم عندما يراها أشبه بالميتة أو الجيفة التي تحيط بها الكلاب [18]:
أصاح هي الدنيا تشابه ميتة ونحن حواليها الكلاب النوابح
وغرض آخر أعلن اختياره هو “تمجيد الله”، وما يتخلله من “عظة”. وهو أيضا ظاهر في اللزوميات، وإن يكن تمجيدا مغايرا للتمجيد التقليدي، ومختلطا بطريقة أبي العلاء. فالعظة التي تعني الإفادة من درس الدنيا، واتخاذ موقف منها، والاتجاه إلى “الله” هي المسافة التي يحاول المعري ملأها. المسافة من الدنيوي إلى الإلهي، وهي بلا شك مسافة وجودية مستحيلة الملء، وفي هذه المحاولة كانت اللزوميات.
أما الشكل الإيقاعي الذي اختاره فيتضمن تفسير التسمية: ” لزوم ما لا يلزم، ومعنى هذا اللقب أن القافية تلزم لها لوازم لا يفتقر إليها حشو البيت ولها أسماء تعرف”. ثم لخص قواعد القافية واستخلص تسمياتها ومصطلحاتها العروضية، فوجد أنها تتمحور في مصطلحات تتصل بالحروف، وهي 6: الروي، والردف، والتأسيس، والوصل، والخروج، ولهذه الخمسة 12 منزلة أو صورة بحسب صور استعمالاتها في الشعر العربي. أما الحركات فمصطلحاتها 6: الرس، والإشباع، والحذو، والتوجيه، والمجرى، والنفاذ. ومنازل الحركات أيضا 12 منزلة أو صورة. وقد شرح هذه المصطلحات وناقشها مناقشة دقيقة وضرب أمثلة عليها من الشعر القديم.
ثم جاء لالتزاماته الإضافية التي “لا تلزم” بمعنى أنها لم تكن تشترط، فهي إذن قيود إضافية إلى القيود اللازمة، قال: “وقد بنيت هذا الكتاب على بنية حروف المعجم المعروفة ما بين العامة، لا التي رتبها العلماء بمجاري الحروف، (أي ترتيب: ألف باء، الهجائي، وليس الترتيب الصوتي).. وقد تكلفت في هذا التأليف 3 كلف:
الأولى: أنه ينتظم حروف المعجم عن آخرها.
والثانية: أنه أن يجيء رويه بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك.
الثالثة: أنه لزم مع كل روي فيه شيء لا يلزم من ياء أو تاء أو غير ذلك من الحروف” [19].
وأخيرا فإن أبا العلاء شيخ المعرة رحمه الله شيخ عقلاني مؤمن من نوع فريد، صدق بالنتيجة الكلية، ولكنه لم يطمئن إلى الطرق الموصوفة إليها، ومن هنا نسوي بعض ما قد يظنه القارئ تناقضا أو مفارقة بين إقراره الإيماني في مواضع كثيرة من شعره ونثره، ونقده أو تجديفه في مواضع أخرى. إنه لا يجدف إلا ضد ما يعده طرقا مستهلكة في معرفة الله، وهي طرق لم تقنعه ولم تدل عقله المضيء، فالخلق ليس عبثا وفق منظوره، ولكن ما لم تتوصل الأذهان والعقول إليه هو فهم التفاصيل إلى تلك الكليات فهما سليما. ولقد رفض كل مذاهب عصره، ونقدها نقدا صريحا، وكأنه يمهد السبيل لفلسفة “جديدة” وفهم “جديد” للعقل. نقد المرجئة والمعتزلة والتصوف والتشيع، بل نقد المذاهب كلها. نقد فهم الناس لها. وحاول أن يرى جوهرها على هدي تأملاته الفريدة.
أما مراده الأخير أو العالم المثالي الذي يطلبه فيبدو وسط ضباب الصورة السوداء، إنه ليس مطلبا عسيرا ولكن اقتتال البشر وفسادهم جعل عالمه المأمول مستحيلا. ومن الصور الواضحة القليلة التي عبر فيها عن مراده المأمول قوله [20]:
ما أحسن الأرض لو كانت بغير أذى ونحن فيها لذكر الله سكان
الهوامش والإحالات:
[1] . الخطيب البغدادي، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، (ت463هـ)، تاريخ مدينة السلام، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، 2001م، 5/398.
[2] . أبو البركات ابن الأنباري، (ت577هـ)، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق إبراهيم السامرائي، دار المنار، الزرقاء-الأردن، ط3، 1985م، ص 258-259.
[3] . من مقدمة التبريزي، ضمن: شروح سقط الزند، تحقيق مصطفى السقا ورفاقه، بإشراف طه حسين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3، 1986م،1/3.
[4] . من مقدمة الخوارزمي، ضمن: شروح سقط الزند، 1/18.
[5] . ديوان سقط الزند، طبعة أمين هندية، القاهرة، 1901م، ص 33.
[6] . المصدر نفسه، ص 35.
[7] . المصدر نفسه، ص 44.
[8] . المصدر نفسه، ص 46.
[9] . المصدر نفسه، ص 82.
[10] . اللزوميات، تحقيق أمين الخانجي، 1/ص1. وشرح اللزوميات، بإشراف حسين نصار، 1/19.
[11] . المصدر نفسه، 3/31.
[12] . المصدر نفسه، 1/66.
[13] . شرح اللزوميات، بإشراف حسين نصار، 1/297.
[14] . شرح اللزوميات، بإشراف حسين نصار، 2/91.
[15] . المصدر نفسه، 2/97.
[16] . المصدر نفسه، 1/3.
[17] . المصدر نفسه، 1/58.
[18] . المصدر نفسه، 1/344.
[19] . اللزوميات، طبعة الخانجي، 1/22-23. وشرح اللزوميات، بإشراف حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1/40-41.
[20] . المصدر نفسه، 3/212.